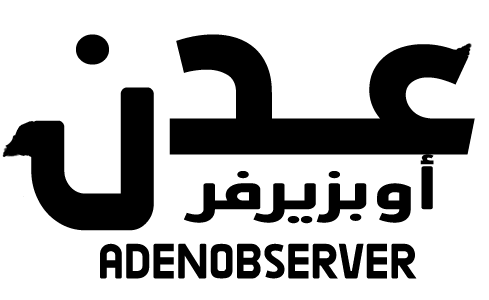حرية ووباء العنصرية ..

كل إنسان يحمل في داخله ثنائية الخير والشر، فلا بأس أن يبغض أو يحب، أن يسعد أو يغضب، أن يؤمن أو يكفر، ما دام أن تعاملاته لا تؤذي أحدًا، على اعتبار أن ما يقوم به يخصه هو وحده، ولا يتم فرضه على الآخرين . هذه هي منطقة الحرية الشخصية المصونة.
وهذا هو الفارق الجوهري بين حرية الاعتقاد التي تصونها القوانين، وبين فرض الوصاية الذي يؤدي إلى الاستبداد. فالضمير الإنساني مملكة خاصة، لكنه حين يتحول إلى مشروع سياسي أو اجتماعي، يصبح ملكًا للجميع، وعليه يخضع للمساءلة.
لكن المكمن الخطر أن يكون هذا الشخص يمارس نشاطًا عامًا، أو يشغل وظيفة عمومية، أو يرأس حزبًا سياسيًا. هنا، يتحول الشر لديه إلى كارثة إنسانية، ويصبح بغضه وكفره متجاوزين لحدود حريته الفردية ليُفرضا قسرًا على المجتمع.
ويقينًا أنه ما من دين إلهي يمكنه أن يشرعن تصنيف البشر إلى أسياد وعبيد، أو أن يحتقر لونًا ويفضل آخر . فهذه التقسيمات هي صناعة بشرية خالصة، لا علاقة لها برسالات السماء أو نواميس الكون.
فاليهودية، على سبيل المثال، تم اختزالها بفئة أطلقت على ذاتها “شعب الله المختار”، والأهم، لكي تكون يهوديًا، لا بد أن تكون أمك يهودية بنت يهودي. وبهذا التصنيف الضيق ، أغلقت اليهودية أبوابها في وجه مريديها من الأمم الأخرى، محتفظة بتميزها العرقي .
أما النازية والفاشية، فصعدتا بقوة الصاروخ، ووصلت جحافلها لحد اجتياحها لأغلب أوروبا وأفريقيا وآسيا. ومع هذا وذاك، انهارت وسقطت ، وسبب هزيمتها الماحقة لم يكن نتاج ضعف قوة أو اقتصاد، بل كان بسبب عنصريتها المقيتة التي أفنت المقاومة في قلوب الشعوب قبل أن تحصد الأرواح.
ومع أن رايات النازية سقطت عسكريًا، إلا أن أفكارها تتناسخ في ثياب جديدة؛ فتراها في خطابات الكراهية ضد الأقليات ، وفي قوانين التمييز العنصري المقنع، وفي شعارات ‘تفوق العرق’ التي ترفعها بعض الجماعات هنا وهناك. إنها الهيدرا، ذلك الوحش الأسطوري الذي ينبت له رأسان كلما قُطع رأس .
فالعنصرية، ببساطة، هي برنامج انتحاري جماعي ؛ لأنها تنفي الإنسانية عن الآخر، فتستبيح دمه وكرامته، ثم تفاجأ بأن هذا الآخر ينتفض لاستعادة إنسانيته.
التاريخ لا يرحم القادة أو الأنظمة التي تبني أمجادها على قبور الفئات أو الأجناس الأخرى ؛ إنها كالبناء على الرمال، ينهار بأول هزة وجدانية تعترض مساره .
وغالبًا ما تكون النزعة القومية المتطرفة أو الدينية المشوهة طريقةً سهلةً لجذب الجماهير، وأسلوبًا مؤثرًا يُصعِد بهؤلاء الدعاة إلى القمة. لكنها شعبوية لا تدوم، وطريقة مضللة سرعان ما تتلاشى وتسقط عند أول اختبار جدي وممارسة فعليّة على أرض الواقع.
تأملوا جيدًا: كم هي الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا أو آسيا؟ وماذا حققت من نجاحات اقتصادية واجتماعية ملموسة لتلك المجتمعات؟ .
يبدو أن أسهل وسيلة للوصول إلى السلطة، أو للظفر بثقة البسطاء والسذج، هي أن تعزف على وتر العصبية للمكان أو الجنس أو الدين . إنها أفيون الشعوب الجديد، لكن مفعوله لا يدوم طويلًا .
في النهاية، تبقى العنصرية ذلك السرطان الخبيث الذي ينهش جسد الإنسانية من الداخل ، فهي ليست مجرد فكرة خاطئة يمكن دحضها بمنطق، بل هي آفة روحية تجعل من يحملها أعمى عن رؤية جوهر الإنسان في الآخر .
لقد أثبت التاريخ أن كل فكرة أو مشروع قام على تفوق عرق أو دين أو جنس أو فئة أو جهة هو مشروع محكوم عليه بالفشل، لأنه يبني صرحه على أنقاض الكرامة الإنسانية.
الخطر لا يكمن في إنسان يبغض أو يحب في قرارة نفسه، فالقلوب لا تملك عليها. الخطر كل الخطر في تحويل هذا البغض إلى سلطة دولة وبرنامج عمل، وفي تحريك الجماهير باسم العصبية العمياء، وفي تحويل الاختلاف إلى سيف يقطع أواصر الإنسانية التي تجمعنا.
فقبل أن نكون مسلمين أو يهودًا، عربًا أو غربيين، سودًا أو بيضًا، نحن قبل كل شيء بشر، وهذه الإنسانية هي الهوية الوحيدة التي تستحق أن نضحي من أجلها.
وفي كل الأحوال، يزخر التاريخ بالعديد من النماذج البشرية العنصرية التي يخجل المرء من ذكر جرائمها بحق الإنسانية ، فهل نتعلم من دروس التاريخ الماضية، قبل أن نكون مادة لدروس قاسية في المستقبل؟ .
هل نختار أن نصنع تاريخًا من التسامح والتعايش، أم نكرر أخطاء الماضي ليكون شاهدًا على فشلنا؟ القرار، كما كان دائمًا، في أيدينا.
نعم ، نحن مخيرون ، فإما ننحاز للإفكار الكبيرة التي تجل إنسانيتنا ، وتضعنا في مكانة لائقة بنا ، ولا نخجل منها مطلقا، أو نكون قطيعًا خلف قادة شعبويين عنصريين . في المنتهى الإنسان أين يضع ذاته .
محمد علي محسن