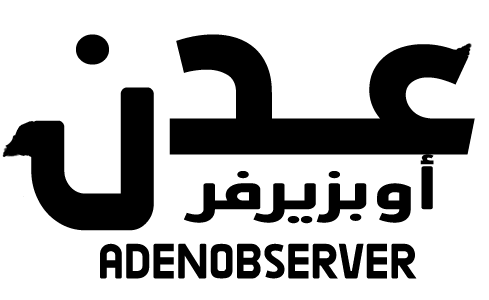ترامب و”وزارة الحرب”: اللغة حين تتحول إلى إعلان عقيدة سياسية

علي قاسم
تبني القوة بلا مواربة
لم يكن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه إعادة تسمية وزارة الدفاع الأميركية إلى “وزارة الحرب” مجرد تعديل بيروقراطي في لافتة مبنى البنتاغون. فالخطوة، بكل ما تحمله من حمولة تاريخية ورمزية، تمثل في جوهرها إعلانًا صريحًا عن تحوّل في العقيدة السياسية الأميركية، من خطاب يغلّف القوة العسكرية بعباءة “الدفاع” إلى خطاب يفاخر بوضع الحرب في صدارة أدوات الدولة.
منذ عام 1949، حين استبدلت الولايات المتحدة تسمية “وزارة الحرب” بـ”وزارة الدفاع”، كان الهدف المعلن هو التكيف مع نظام دولي جديد بعد الحرب العالمية الثانية، وإبراز دور أميركا كقوة ضامنة للاستقرار، لا كقوة غزو. كان ذلك زمن التوازنات الدقيقة، حيث كانت الدبلوماسية تتقاسم الأضواء مع القوة العسكرية. أما اليوم، فإعادة إحياء هذا الاسم تبدو كخطوة متعمدة للعودة إلى زمن كانت فيه القوة العسكرية هي اللغة الأولى للسياسة الدولية.
تخيل المشهد: موظفو البنتاغون يدخلون مكاتبهم صباح الجمعة، ليجدوا أنفسهم فجأة يعملون في “وزارة الحرب”. الكلمة نفسها تحمل ثقلاً نفسيا وسياسيا يختلف تماما عن “الدفاع”. فالأولى تستدعي صور الهجوم والصراع المباشر وفرض الإرادة بالقوة، بينما الثانية توحي بالحماية والرد على التهديدات. هذا التحول في التسمية ليس بريئا، بل يعكس رؤية ترامب التي طالما نادى بها: أميركا كقوة عظمى لا تتردد في استخدام قوتها الصلبة لتحقيق مصالحها، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو إستراتيجية.
في قلب هذا القرار تكمن رؤية قومية شعبوية ترى في مصطلح “الدفاع” ضعفا أو ترددا لا يليق بصورة أميركا التي يريدها ترامب. بأسلوبه المباشر، يعلن أن العالم يحترم القوة أكثر من الحوار، وأن الصراحة في توصيف دور الجيش تعزز الثقة وتوحد الصفوف خلف القيادة. داخليا، يخاطب هذا التوجه شريحة من الأميركيين ترى في القوة العسكرية مصدر فخر وركيزة للهوية الوطنية، ويعتبر أن تسمية “وزارة الحرب” تعكس الحزم والهيمنة بلا مواربة.
لكن الرسالة ليست موجهة إلى الداخل فقط. خارجيّا، هي إشارة واضحة إلى أن القوة العسكرية ستكون في طليعة أدوات السياسة الأميركية، خاصة في ظل تصاعد التوترات مع قوى دولية كالصين وروسيا. إنها رسالة ردع، لكنها أيضا إعلان عن استعداد للهجوم إذا اقتضت المصالح ذلك. في عالم يشهد تحولات حادة وصراعات مفتوحة، قد يُقرأ هذا القرار كتصعيد في الخطاب الأميركي، ما يزيد من حدة الاستقطاب الدولي ويؤجج سباق التسلح.
البعد الدعائي والسيكولوجي حاضر بقوة. يدرك ترامب أن الأسماء تصنع الانطباعات، وأن تغيير كلمة واحدة يمكن أن يعيد تشكيل وعي الجمهور. “وزارة الحرب” ليست مجرد توصيف وظيفي، بل شحنة نفسية ورسالة سياسية في آن واحد. إنها تقول: نحن لا نختبئ خلف لغة دبلوماسية ناعمة، نحن نسمّي الأشياء بأسمائها، ونعلن أن قوتنا العسكرية ليست أداة دفاعية فحسب، بل وسيلة هجومية لحماية مصالحنا وفرض إرادتنا.
هذه الصراحة الفجة تتناغم مع أسلوب ترامب الذي يرفض “التجميل” اللغوي، ويعتمد على خطاب القوة والفخر الوطني. وفي موسم انتخابي أو في ظل استقطاب داخلي حاد، تصبح مثل هذه الخطوات وسيلة لتعبئة القاعدة الانتخابية، وإشعال مشاعر الفخر القومي، وربما صرف الأنظار عن ملفات داخلية شائكة.
لكن، كما هو متوقع، لن يمر هذا القرار دون جدل. داخل الكونغرس، ستشتعل النقاشات بين مؤيدين يرون في التسمية الجديدة تعبيراً عن الصراحة والواقعية في توصيف الدور الحقيقي للمؤسسة العسكرية، وبين معارضين يخشون أن تكون هذه الخطوة إشارة إلى عسكرة السياسة الخارجية وتكريس نهج يقوم على المواجهة بدلاً من الدبلوماسية. أما على الصعيد الدولي، فقد يرى الحلفاء والخصوم في القرار إعلاناً عن مرحلة جديدة من التوترات، وربما بداية لحقبة تتراجع فيها لغة التفاوض أمام منطق القوة.
تاريخيّا، لم يكن اسم “وزارة الحرب” غريبا عن الولايات المتحدة. منذ تأسيس المؤسسة العسكرية عام 1789 كان هذا هو الاسم الرسمي حتى عام 1947، حينما تم تقسيمها إلى وزارة الجيش ووزارة القوات الجوية اللتين انضمتا إلى وزارة البحرية لتشكيل ما عُرف آنذاك بـ”المؤسسة العسكرية الوطنية”، والتي سُميت في عام 1949 باسم وزارة الدفاع الأميركية؛ فبعد الحرب العالمية الثانية، ومع بداية الحرب الباردة، اختارت أميركا تغيير الاسم في محاولة لتأكيد دورها كحامية للنظام الدولي الجديد، بعيدا عن نزعات الهيمنة العسكرية المباشرة. إعادة إحياء هذا الاسم اليوم لا يُقرأ فقط باعتباره عودة إلى الماضي، بل يُفهم في إطار رؤية ترامب القائمة على “السلام من خلال القوة”، والسعي إلى إعادة فرض صورة الولايات المتحدة كقوة عسكرية مهيمنة لا تتردد في استخدام قوتها الصلبة لحماية مصالحها.
قد يبدو القرار، للوهلة الأولى، نزوة لغوية أو استعراضا انتخابيا، لكنه في جوهره امتداد لإرث طويل من السياسة الأميركية التي لم تتردد يوما في استخدام القوة العسكرية كأداة أولى، لا كملاذ أخير. فمن فيتنام إلى العراق، ومن أفغانستان إلى التدخلات الخفية في أميركا اللاتينية وأفريقيا، ظلّت واشنطن تبرر حروبها تحت شعارات متغيرة: “الدفاع”، “الحرية”، “الحرب على الإرهاب”.
اليوم يسقط ترامب ورقة التوت الأخيرة، معلنا أن الحرب ليست فقط وسيلة مشروعة، بل عنوان المرحلة. إنها عودة إلى لغة القرن التاسع عشر، حيث كانت القوة العسكرية معيار الهيبة، وحيث كانت الإمبراطوريات تُقاس بعدد الأساطيل لا بعدد الاتفاقيات.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: إذا كانت أميركا، وهي القوة العظمى التي صاغت النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، تعود إلى تبني خطاب “وزارة الحرب”، فماذا يعني ذلك لمستقبل هذا النظام؟ هل نحن أمام بداية مرحلة جديدة من سباق التسلح والمواجهات المفتوحة، أم أن العالم سيتكيف مع أميركا أكثر صراحة في إعلان نواياها؟
ربما يكون الجواب الأهم أن هذه الخطوة، مهما بدت رمزية، تكشف عن تحوّل أعمق في العقل السياسي الأميركي: من دبلوماسية تضع الحرب في الظل، إلى سياسة تضعها في الواجهة بلا مواربة. وهنا، يصبح السؤال ليس عن ترامب وحده، بل عن أميركا التي يريد أن يتركها للعالم.العرب